
مولد النبي في دمشق.. حيث يموت الجار جوعاً
- بواسطة إياد الجعفري - اقتصاد --
- 30 تشرين الثاني 2017 --
- 0 تعليقات
تابعت بدرجة عالية من الإحباط والأسى، صوراً وفيديوهات تناقلها نشطاء وصفحات في وسائل التواصل، تظهر ازدحام أسواق العاصمة دمشق، بالمتسوقين، بغية شراء حلويات وبضائع تخص مناسبة عيد المولد النبوي، الذي يصادف اليوم.
وقبل أن أتابع، أريد التوضيح بصيغة جليّة للقارئ، أن هذا المقال لا يهدف إلى رفع منسوب المشاعر المناطقية السلبية التي لطالما لعب على أوتارها نظام الأسد، بين الريف والمدينة، من جهة، وبين المدن السورية الكبرى، من جهة أخرى.
لكنه يهدف للتذكير بأن جيراناً يقبعون على بعد كيلومترات قليلة عن دمشق، أطفالهم يعانون من أعلى نسب سوء التغذية التي شهدتها سوريا حتى اليوم.
وفيما تدق منظمات دولية، جرس الإنذار، يتوافد سكان دمشق إلى الأسواق، في حالة من البلادة الكاملة، تجهيزاً للاحتفال بمولد نبي، تعلمنا في المدارس أنه حذرنا من أن ننام "شبعانين"، وجيراننا جوعى.
ندين دوماً المجتمع الدولي، ونحمله مسؤولية الكثير من أوضاعنا السيئة. لكن ذلك المجتمع هو الوحيد الذي يتحدث، عن مأساة جيران دمشق، المحاصرين. وإن كان هذا المجتمع يتحدث فقط، ولا يفعل، فإن سكان دمشق، في جانبٍ كبيرٍ منهم، يفعلون، ولا يتحدثون، ولكن بالعكس. فهم بأفعالهم يمثلون درجة عالية من اللامبالاة والأنانية المفرطة.
وتعقيباً، للمرة الثانية، على المقدمة الخاصة برفض التفكير المناطقي، نُذكّر بأن سكان دمشق اليوم، ليسوا بالضرورة دمشقيون، فهم خليط من نازحين من مناطق ثائرة، إلى جانب شرائح تتحدر من أقليات طائفية موالية للنظام، مضافاً إليهم، ربما، أقلية من سكان دمشق الأصليين. لذا، فسكان دمشق، ربما، يمثلون صورة مصغرى عن السوريين عموماً. وهي صورة صارخة بالمفارقات المؤلمة.
لا يحق لنا، بطبيعة الحال، أن نطالب سكان دمشق بالانتفاض ضد نظام فريد بطغيانه، وهم يشاهدون بأم أعينهم، مصير سكان المناطق الثائرة عليه. لكنه، في نفس الوقت، يحق لنا أن نطالبهم بشيء من الاعتراض الصامت، من قبيل مثلاً، اعتزال الأسواق، وحالات الفرح العامة، كتعبير عن رفض حصار المدنيين في منطقة مجاورة لهم، كانت تعد منذ سنوات، عمقهم الجغرافي والاقتصادي.
قد يقول قائل: في الغوطة نفسها، هناك من يحاصر الغوطة، ويتورط في رفع الأسعار، والاحتكار، وتخبئة السلاح ورفض الانسياق في العمليات المسلحة، تنفيذاً لأجندات تخدم مصالحه. فيما يموت أبناء جلدته، جوعاً. هذه مفارقة مؤلمة أخرى، شهدناها في مناطق محاصرة عديدة، سمحت للنظام أن يحقق مبتغاه في نهاية المطاف، وفي كل مرة، وبالأساليب ذاتها. وكأن أحداً لا يملك ذاكرة ولو قصيرة المدى، لأخذ العبرة.
لكن ذلك لا يعني، أن لا مسؤولية أخلاقية على أولئك القابعين بعيداً عن التهديد بأمنهم الغذائي، في دمشق. فتلك المسؤولية تقع على الجميع. بدءاً بالنظام، الذي لا يرعى أي أخلاق، مروراً بالممسكين بزمام الاقتصاد والسلاح في الغوطة نفسها، وليس انتهاءً بسكان دمشق.
في بدايات الحراك الثوري، كانت آمال عريضة تداعب أحلام الثائرين بأن سوريا جديدة في طريقها للولادة. سوريا قادرة على التخلص من حالة "الأنا" المفرطة التي علمنا إياها نظام الأسد، منذ عهد الثمانينات، حينما أعمل مبضع الاعتقال والإرهاب بحق الناس، فتعلموا ثلاثاً: ("للجدران آذان"، "أنا ما لي علاقة بغيري"، "ربي أسألك نفسي")، باعتبارها أبجديات النجاة في ظل حكم آل الأسد.
وبدلاً من أن تنهار تلك الأبجديات، تمكن النظام من إعادة إحيائها وبقوة. فحاجز الخوف، دون شك، يفعل فعله في أوساط سكان العاصمة. لكن عوامل أخرى غير مبررة تعتمل في أنفسهم، وتدفعهم إلى الإمعان في حالة "التطنيش" لما يجري حولهم، إلى أن وصل بهم الحال إلى إشهار مظاهر البهجة، فيما يموت جيرانهم جوعاً.
هي صورة مصغرى عن كل سوريا. لا يمكن تغييرها إلا إن تحمل كل منا، مسؤولياته الأخلاقية، ولو بحدودها الدنيا. ولو بالكلمة. وإن كان ذلك صعباً في ظلال نظام الأسد، يكفي الاعتراض الصامت، بأن نعتزل مظاهر الفرح العامة، ولو لحين، كي تصل الرسالة إلى صانع القرار في قمة هرم النظام، بأن القاعدة بدأت تتململ.
إن لم نعي ذلك، فهذا يعني أننا أمام عقود جديدة من حالة "البلادة" الأخلاقية، التي ستعزز أحقاداً مناطقية، لطالما جهد نظام الأسد على ترسيخها في أوساطنا.

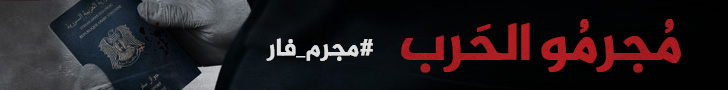






التعليق