
اقتصاديات.. المبررات الاقتصادية للثورة السورية في ذكراها السابعة
- بواسطة فؤاد عبد العزيز - اقتصاد --
- 17 آذار 2018 --
- 0 تعليقات
كان هناك إحساس عام، حتى لدى بعض النخب الحكومية، أن البلد بعد العام 2008 كانت تسير نحو الهاوية في كل شيء، فالصورة كانت واضحة بالنسبة للكثيرين، أن النظام يستبدل السيطرة الأمنية على الشعب السوري، بالسيطرة الاقتصادية.
وتجلى ذلك من خلال عقد تحالفات مع رجال أعمال من كافة المناطق السورية دون استثناء، وخلق مصالح لهم مع السلطة، ومن ثم استخدامهم كأدوات، في التحكم بلقمة عيش المواطن من جهة، ولنهب خيرات البلد من جهة ثانية، وتحويلها إلى الأرصدة الشخصية.
كانت السنوات بعد العام 2006، ثقيلة جداً على الشعب السوري، بعد سنتين من الانتعاش، استمرت من العام 2003 إلى العام 2005.. فقد بدأت الأسعار بالارتفاع، وأخذت الليرة السورية تفقد قدرتها الشرائية دون أن يتغير سعر صرفها بالنسبة للعملات الأجنبية.. فما الذي حدث في ذلك الوقت..؟
باختصار، منذ منتصف العام 2004، قرر النظام أن يمارس دور الأب والذي كان يعيل جميع أفراد أسرته، ثم فجأة تعرض لأزمة مالية، وبدأ يطلب من أولاده أن يغادروا بيته وأن يتحمل كل منهم مسؤوليته الشخصية، لذلك خرج النظام بخطاب جديد عبر رئيس وزرائه آنذاك محمد ناجي عطري، يقول بأن الدولة لم يعد بإمكانها أن تتحمل الدعم على المواد الأساسية الذي تقدمه للشعب السوري، وأنه لا بد من الآن وصاعداً، أن يعتمد المواطن على نفسه في إيجاد مصادر دخل بعيداً عن الدولة.
كان لافتاً في ذلك الوقت أن النظام لم يكن ينتهج هذه السياسة انطلاقاً من فاقة ادعاها بداية، بدليل أنه فتح باب القروض على مصراعيه لمن يريد، بحجة أنها تتناسب مع دعوته الجديدة لأبنائه لكي يعتمدوا على أنفسهم، وأنه ها هو يقدم لهم الفرصة لكي يبدؤوا حياتهم بعيداً عنه.
وخرج يومها المسؤولون الاقتصاديون، ليعلنوا أن البنوك ملآى بالأموال، وبالفعل تم تخفيف الكثير من الإجراءات والضمانات التي كانت مطلوبة للحصول على قرض، والتي كانت محصورة سابقاً بفئة محددة، ثم أصبحت متاحة للجميع..!
كانت الفكرة الجهنمية التي انطلق منها النظام في خطته لاستبدال السيطرة على الشعب السوري، تتلخص بتوريطه بداية بالديون، والتي لن تلبث بعد فترة أن تشكل عبئاً على صاحبها، فيصبح غير قادر على تسديدها والإيفاء بالتزاماتها من خلال الوظيفة الحكومية أو الأعمال البسيطة فقط، وبالتالي لا بد في هذه الحالة أن يبحث عن فرص عمل جديدة وبشروط لا إنسانية، كان النظام يهيئ لها من خلال رجال الأعمال الجدد، الذين أخذوا يظهرون على الساحة تباعاً وبأعداد كبيرة وضمن تشكيلات اقتصادية مريبة، يقودها رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد بالدرجة الأولى، وبعض رجال الأعمال المقربين والمتنفذين داخل النظام والمحسوبين عليه.
أما الخطة الثانية التي كان يهيئ لها النظام في تلك الأثناء، فقد بدأها بالترويج لمشروع دولة جديدة ذات مزايا اقتصادية، وادعى أنه تبنى في الخطة الخمسية العاشرة، مهمة التحول إلى ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، واستقدم لهذا الغرض، شخصاً مغموراً، وكان يعمل صحفياً، اسمه عبد الله الدردري، وسلمه في العام 2005، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأوكل إليه مهمة الإشراف على تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ومن ثم الترويج لها ولشكل الدولة السورية الجديدة مع هذه الإصلاحات.
كان عبد الله الدردري "كلمنجياً"، وقد أبلى بلاء حسناً عندما تسلم لسنتين منصب رئيس هيئة تخطيط الدولة قبل العام 2005، وأثبت الرجل جدارة منقطعة النظير في اقناع مستمعيه بالتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، وبأنها ستعود نهاية بالنفع على الشعب السوري وعلى قوة الدولة، لكن ما على المواطن في البداية سوى تحمل الفترة الانتقالية التي سيسببها هذا التحول الجديد.
كانت سوريا بعد وفاة حافظ الأسد في العام 2000، تواقة للتغيير مهما كان شكله، المهم أن لا يستمر الوضع على ما كان عليه، وقد استثمر النظام هذه الرغبة على أكمل وجه، لكن على طريقته الخاصة، وبما يبقي قبضته قوية على الشعب السوري، سواء على الطريقة الأمنية أو الاقتصادية.
ما حدث بعد العام 2005، أو بالتحديد بدءاً من العام 2006، أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي هدد النظام باتخاذها عبر محمد ناجي عطري وعبد الله الدردري، بدأت تظهر نتائجها على الشعب السوري، وانعكست عليه، من خلال ازدياد حالات الفساد والمحسوبية، وفلتان الأسعار، وتضاؤل فرص العمل التي اخترع لها النظام ما أطلق عليه اسم مكاتب العمل، إذ أنه طلب من كل عاطل عن العمل أن يقوم بتسجيل اسمه في هذه المكاتب، والتي هي بدورها، قامت بالطلب من الجهات الحكومية أن تحصر تعاملها معها في حال رغبتها بتوظيف موظفين جدد لديها، بصيغة العقود السنوية.. فانهال مئات الآلاف من الشباب الذين سارعوا لتسجيل أسمائهم في هذه المكاتب، وأخذوا ينتظرون السنوات من أجل أن تتصل بهم وترشحهم لوظيفة صغيرة في الحكومة.
لقد تبين أن هذه المكاتب، لم تكن سوى وسيلة جديدة لإذلال الشعب السوري، وهدر كرامته، وتعليقه بآمال الانتظار.. وعلى جانب آخر، كانت خيرات البلد تتسلل إلى جيوب النخبة الحاكمة والطبقة الطفيلية التي أوجدها النظام حوله، ومكنها من لقمة عيش المواطن.. فأخذت الأسعار ترتفع بشكل شبه يومي، وغابت الأجهزة الرقابية عن الأسواق، بحجة السوق المفتوحة أنها تستطيع أن توازن نفسها من خلال التنافس بين التجار والمستوردين.. بينما في المقابل فإن هذه السوق لم تستطع أن تتوازن لأنه بالأساس لا يوجد متنافسين، وإنما تم تقاسم الحصص بين هذه الطبقة الطفيلية، من أجل أن لا يتنازعوا فيما بينهم ويضطرون للاضرار بمصالح بعضهم البعض..
الكثير من المنظرين للثورة السورية، كتبوا فيما بعد، محاولين تفسير هذا الهيجان الشعبي الذي أطلق عليه الثورة السورية في العام 2011، والذي لم يكن للمعارضة أي دور فيه، بأنه لا يمكن أن يكون ناتجاً عن وعي سياسي، وإنما كان محركه الأساس ظروف الفساد والإفقار والقهر الاجتماعي التي فرضها النظام على الشعب السوري، وصولاً إلى إخراجه بالكامل من معادلة ممارسة السلطة بأي شكل من الأشكال، وتحويله إلى ديكور فقط في الدولة الاستبدادية.
ولعل من يتذكر الأيام الأولى للثورة، يدرك هذه الحقيقة، عندما خرجت الناس دون أن تكون قادرة على الهتاف بمطالبها السياسية، لذلك كانوا تارة يكبرون، وتارة أخرى "يصفرون"..
وعندما بدأت مطالب الثورة السياسية تتبلور بعد نحو شهر على انطلاقتها، عبر النخب التي تولت إيصال هذه المطالب للسلطة، أحس الكثير من المتظاهرين، بأنها لا تستحق حجم التضحيات المطلوبة منهم لتحقيقها، لأن الحياة السياسية في سوريا كانت فقيرة، إلى الحد الذي لم يكن أحد يعرف ماذا يعني إلغاء قانون الطوارئ ومردوده الاقتصادي، أو ما هو المقصود بالحرية والديمقراطية وكيف يمكن أن تنعكس إيجاباً على حياتهم المعاشية.. ولولا أن النظام واجه هتافاتهم بالرصاص والقتل، لما كانوا أدركوا إطلاقاً أهمية تلك المصطلحات السياسية المتضمنة في هتافاتهم، وكيف أنها الأساس لكي يحيا الإنسان كريما ًفي وطنه ومتساوياً مع الجميع في الحقوق والواجبات، تحت سقف القانون.
خلاصة الكلام: يمكن القول أن أغلب مبررات انطلاق الثورة السورية، كانت في جوهرها اقتصادية، ثم بعد فترة وجيزة وعت الجانب السياسي وبأنه السبب في كل هذا الظلم والفساد الذي يتعرضون له.. وبعد ذلك رأت فئة دخيلة على الثورة، أن سبب هذا الظلم ديني وعقائدي، فلو أن حكام سوريا يؤمنون بالله "عن جد"، لما ظلموا الناس.. وهنا دخلنا في "الحيط" الذي لازلنا نتصارع معه حتى اليوم..

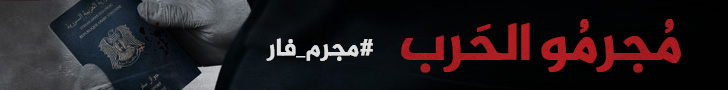






التعليق